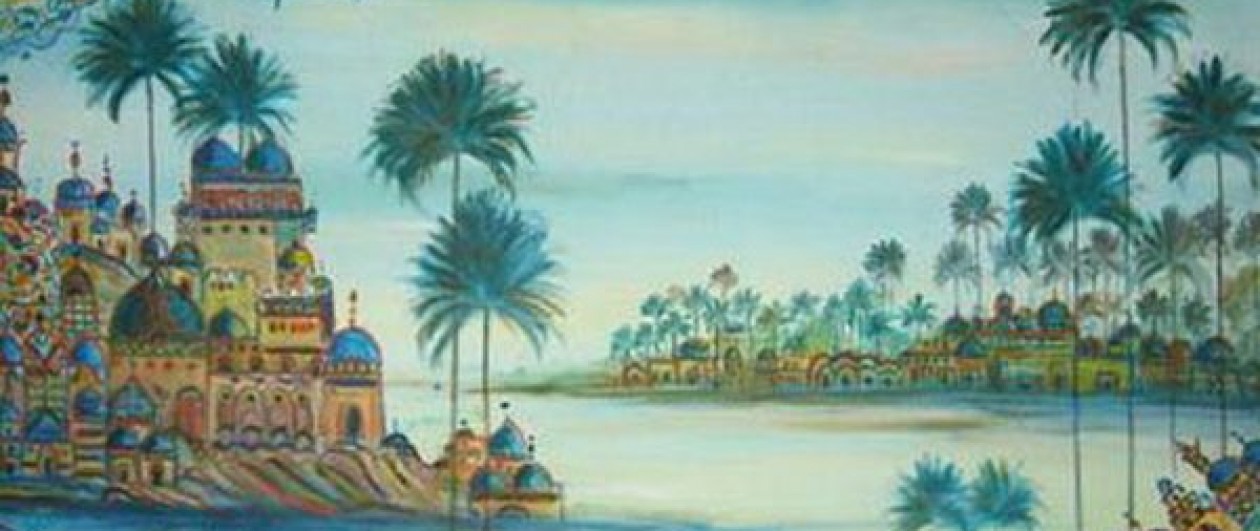قبل البدء
يجيد الرجال صنع الأشياء في أكثر الأحيان أفضل من النساء، لكنهم لا يستطيعون أن يحبوا تلك الأشياء الجيدة، أو أن يتركوا فيها شيئا من ذواتهم، كما تفعل النساء مع الأشياء اللاتي يُجدن صناعتها.
أيضا قبل البدء
تصنع أمةٌ ما شيئا، لنقل نوع من الطعام، فتأخذه أمة أخرى، وتجوّده، وتحسنه، وتمنحه روحا جديدة ومذاقا أكثر حبا ودفئا، مثل الفسنجون، الذي صنعه الإيرانيون، وجوّده النجفيون غاية التجويد.
ما عرفت أكلاً يتطلب وقتا طويلا ومهارات خاصة، وكلف باهضة، مثل الفسنجون في النجف، تعمد المرأة إلى إعداده فتطلب حب الرمان المجفف ـ وتستصغر قدر من تشتري ماء الحب الجاهز لطبختها ـ والراشي – عصير السمسم ـ من أجوده، والجوز، وتفضل لحم البط لما فيه من دهن، ومستلزمات أخرى غالية الثمن لا أكاد استحضرها اليوم.
ثم تنفق ساعات طوال في غلي حب الرمان، وعصره في كيس من الخام، وساعات أخرى في مزج المكونات بدقة وخبرة، بعين لا تخطئ، ولا تستخدم الميزان لإضافة المكونات.
وتراقب المرأة القدر لساعات أخرى، كأنها تراقب رضيعها، تشمه، تتذوقه، تحرص على تشكله في قوام معين ، بعض النساء النجفيات يخزنَّ بذور الرقي – البطيخ بلهجة غير العراقيين ـ فتقليه بدون دهن، وتطحنه ناعما، وتضيفه حتى يصل القوام لحد ترتضيه.
لا تكاد المرأة تبارح مطبخها حين تعده، ينتهي يوم كامل في طبخ هذا الطعام الذي لا يعرفه غير أهله، ولا يقدره غير بنو المدينة التي تجيد طبخه، وآخرون ممن يفدون على أهلها، أكلة الملوك، هكذا يسمونها.
أجد البعض يذكر أن فلانا من الرجال يجيد طبخه في المطعم الفلاني، فلا أصدق قولهم، ولا أرغب حتى بإقامة دليل عليه، لأن لي في هذا النوع من الأكل رأي أزعمه.
إني أرى أن هذه الأكلة مما تختص بصنعه النساء فحسب، لأنها تحتاج رعاية كتلك التي تمنحها الأم لطفلها، ولا يجيد الرجل تلك الرعاية مهما بالغ، يعرف الطفل أمه من رائحتها، وتعرفه منها، ولا يكاد الرجل يستطيع أن يتحمل بكاء الرضيع ساعة، في حين تسهر أمه معه ليالي طوال، حتى تبكي معه عاجزة عن فهم ما يريد، فيتبسم في وجهها، لتنسى ألم السهر، ووجع الليل كله، فتضحك ملئ روحها جذلا بالمبتسم الباكي بين ذراعيها.
للفسنجون روح امرأة، بذلت وقتا في إعداده لأسرتها بحب، راقبته يتشكل ويأخذ قوامه المتين ساعة تلو ساعة، حتى نضج، كما ينضج الطفل عقب سنوات تربيته، تقوم المرأة النجفية عليه كما الطفل، شدة حيث ينبغي، ولطف حيث يستحق، ورعاية دائمة وعين لا تغفل عن المراقبة، حتى تضع فيه من روحها شيئا، فيتجلى بلونه البني الغامق، ورائحته المميزة، تضعه على المائدة وتراقب قسمات وجوه المستحسنين، كأنهم يقولون لها أحسنت التربية، أو أحسنت الطبخ.
للفسنجون روح امرأة، ولا يجيد الرجل بث روحه فيه بحب، كما تفعل النساء، لهذا أقول للسائلين عنه من غير أهل المدينة الصلبة الغريبة المزاج، لا تتعبوا أنفسكم في طلبه عند أهل المطاعم، هذا أكل تطبخه النساء، في البيوت، لتكون له رائحة البيت، ومحبته الوالدة، وعاطفة المرأة، ورقة الفتاة الناهد، إنه طفل يحتاج لأسرة تحتضنه، لأم تناغيه وتسهر عليه، وليس لأب متجهم يقيس كل شيء بالمسطرة، للفسنجون روح امرأة، لا يصلح بدونها، ولا يستقيم.
هذه أكلة لا تتعلمها المرأة من اليوتيوب، إنها مهارة تكتسبها من أمها، كما تكتسب طباعها وسجيتها في الحياة، هذه أكلة حسيّة لا يحسن العقل صنعتها، إنها تعتمد العاطفة، الحب في موازنة مكوناتها وتشكيل كينونتها، إنها روح لا تنضج بدون حب خالص لا تشوبه خشونة الرجال وغلظتهم، للفسنجون روح امرأة، لا يصلح بدونها ولا يستقيم.