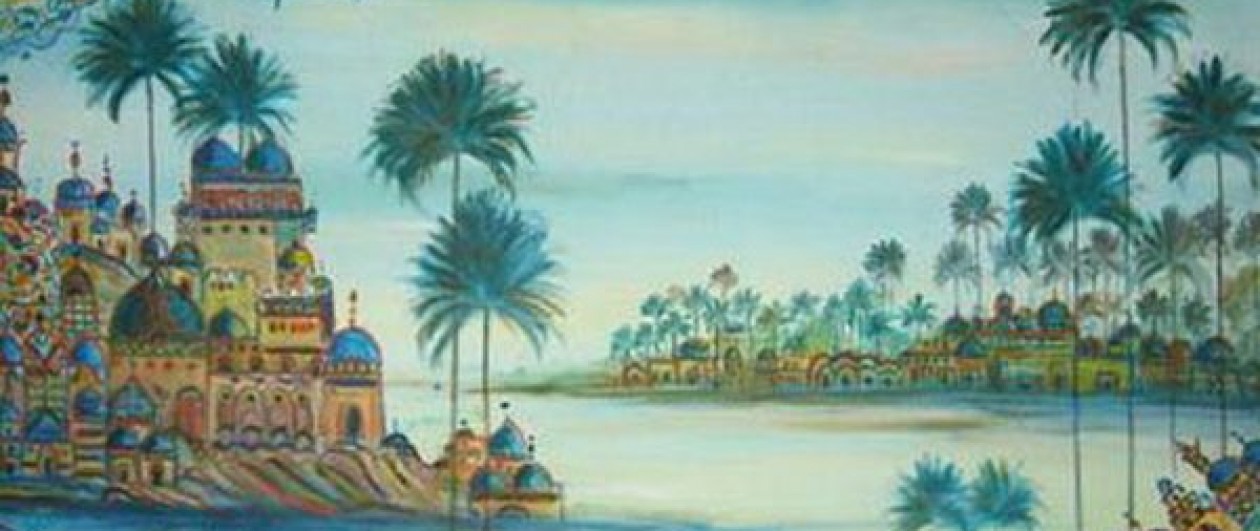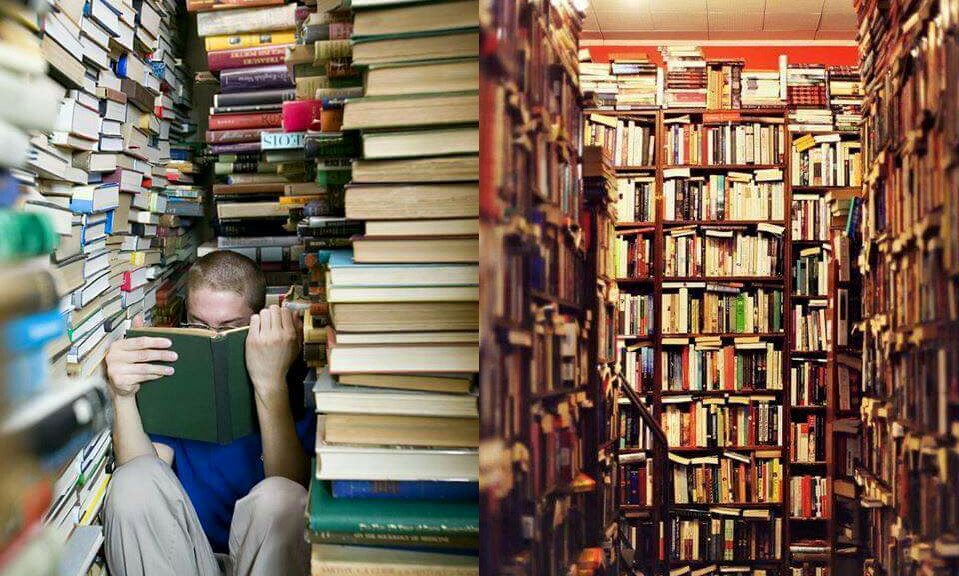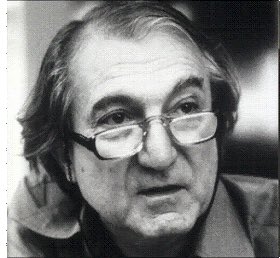علي عبد الهادي المعموري
تخبرك الاحياء، شوارعها، عمارتها، بالكثير عنها، وساكنيها.
هناك شارعين في الكرادة أمر بهما بشكل يومي تقريبا ـ على التناوب في أحيان كثيرة، بحسب مزاجي ـ أنا أعني الشارعين المحصورين بين شارع السبع قصور، السبع الغاربات، وشارع سيد إدريس، من الكرادة داخل إلى الخارج، أو العكس فالأمر سيان، ولا يندرج شارع السبع قصور، أو شارع السيد إدريس بذاته ضمنهن.
إذا كنت قادما من الكرادة داخل ـ الجوة ـ باتجاه مرقد السيد إدريس الحسني، وما أن تجتاز تقاطع السبع قصور ـ عند مرطبات جوز وموز، أم جوز ولوز؟ تاه الأمر علي ـ الفرع الأول على يسارك في جهة السيد إدريس وليس جهة أبي نؤاس، بداية الفرع مميزة، افتتاحية قوية، مدرسة على يمينك وأنت داخل الفرع، ومحل لبيع الدجاج والأسماك على يسارك، العقل والبطن معاً!
هذا الشارع، على طوله، يندر أن تجد فيه منازل من تلك القديمة المشادة حين بدأت الحياة هنا، لم يتبق سوى بعض البيوت، قد تشكل 10% من الشارع، أما البقية، وعلى امتداده وصولا إلى عمارة الحريري، أغلبها تحولت إلى ما اسميه عمارات إيراد التقاعد، العمارات المرتجلة، بلا تخطيط، ولا هندسة، قد يبنيها متقاعد بقرض حكومي في حديقة بيته، أو ببيته كله، دون مصاعد، دون إضاءة جيدة، دون واجهات معمارية، ولا مخارج طوارئ، ولا أي شيء موافق لمعايير البناء حتى لدى أمانة بغداد المتخلفة، كتلة مكعبة من الكونكريت يصممها محترف صب كونكريت، لا معمار ولا هم يحزنون، تحشر فيها العائلات حشرا، وبإيجارات تتصاعد حسب المنطقة، يتعيش منها المالك، وقد يوكل بها احد ويذهب ليسكن في تركيا أو في أي بقعة آدمية أخرى، وينتظر كل رأس شهر إيجاراته بوصفه ملاك، كأنه عبد الهادي الجلبي في زمانه!
على هذا، ساكني الشارع في اغلبهم من متوسطي الدخل، موظفين يسكنون في شقق مستأجرة، أو في مشتمل مرتجل في حدائق آبائهم، باستثناء مسئول لا اعرفه تتكدس سيارات الحكومة أمام بابه ـ الغريب أنه لم يختر الشارع الآخر، الهادئ، وحشر نفسه هنا ـ الشارع مظلم في الليل، احد ساكنيه يمتلك سيارة فولكا روسية من الطراز الحديث ـ الذي دخل العراق قبيل 2003 وقام العراقيون بتبديل محرك السيارة لاحقا بمحرك كراون/ تويوتا ـ حول الرجل باب بيته، وصندوق سيارته إلى محل خضروات يتسوق منه جيرانه.
وأنت تسير فيه، تكاد تختنق، الشارع فيه بعض النخيل وبعض الاشجار الخجولة، ضيق الشارع لا يسمح بالكثير، وتبدو في منتصفه، ما تبقى من نخلات آخر القصور السبعة الغاربة في حديقته الخلفية التي بنى احدهم فيها بيتا رثا، تضايقك السيارات المرصوفة على جانبيه، والسيارات القادمة والذاهبة بسرعة ـ لدي ذكرى سيئة بسيارتي في هذا الشارع، كنت لا أزال سائقا حديث العهد حين استدرت دون أن انتبه لفتحة التصريف في الأرض التي كانت قيد الإنشاء فتمزق الإطار شر ممزق، وأخبرني احد ساكني الشارع أنني لست أول من تورط فيها ـ ولن تعدم وأنت تمشي أن تتعثر بطفل سرحه أهله إلى الشارع خارج علبة الباطون الضيقة التي يسكنونا، ويعدونها بيتا، ومشهد الأطفال في الشوارع مألوف في أي منطقة شعبية، أو شبه شعبية، أو فقيرة بالمختصر.
كما أنك ستجد أيضا على طول الشارع شباب فرادى ومجاميع، بعضهم يدخن النارجيلة أو الفيب الالكتروني، وقد انزوى أحدهم بعيدا في جانب مظلم، يتصل بصوت خفيض وابتسامة سعادة بلهاء تغمر وجهه الساذج الذي لا يدري ما ينتظره عقب مراهقته هذه، ولن تعدم مجموعة من العجائز، ذكورا، أو إناثا كل في مجموعته الجندرية، يتحدثون في كل شيء، من كيفية طبخ الدولمة التي يبالغ العراقيون في تقديرها، وصولا إلى أزمة البلقان وتهديد بوتين للاتحاد الاوربي وآخر تحركات الناتو والازمة الايرانية الامريكية التي تلقي بجحيمها علينا.
كل ما في الشارع ينبيك بمستوى أهله الاقتصادي، البنايات القبيحة، السلالم بالغة الخطورة التي ارتجلت لتحويل البيوت إلى شقق، حتى الأثرياء من بينهم الذي هدموا بيتا تراثيا هناك وشيدوا محله بيتا جديد، تخبرك واجهة البيت الرثة، بألوانها الصارخة، من أي بيئة انحدروا، أو بأي مزاج تأثروا.
وأنت تسير، هناك فرعين، بينهما مسافة ليست قصيرة، يصلان بين شارع الطبقة شبه المتوسطة، شبه الرثة هذا، وبين الشارع الثاني محل الحديث، يبدأ الشارع من مستشفى جنين، وينتهي بشارع عرضي يقودك إلى نهاية الشارع الأول، صاحبنا، ثم خروجاً لعمارة الحريري وتقاطع السبع قصور الذي يضم مطعم فرايد جكن ومرطبات البلوط، وغيرها.
الفرع الأول قريب للشارع، شارع المدرسة آنف الذكر، ما أن تدلف وتسير مسافة قليلة يلاقيك على يمينك، تدريجيا تتبين الاختلاف بين الشارع الذي كنت فيه، والذي صرت إليه مسيرا للذي ستصله، تبدأ البيوت تكبر تدريجيا، وإن كنت لا تعدم تكدس السيارات فيه، وتحول بعض البيوت إلى عمارات إيراد التقاعد المعروفة، ولكنه شارع فسيح، تقريبا ضعف مسافة الشارع الذي تركته خلفك، شارعنا سالف الذكر، وبشكل غريب، فإن فرع الوصل الثاني لا يختلف عن فرع الوصل الاول، كلاهما برزخ ينقلك من بيئة لأخرى، من طبقة لأخرى، بالتدرج، الفرع الثاني يبدأ ببيت فخم، رث الواجهة، حجر أبيض سخيف من الذي أصيب صدام بالهوس بشأنه في التسعينات فحول المجمع الرئاسي إلى كتل بيضاء قبيحة.
وأنت تمشي وئيدا، تصل لشارعنا الثاني، لتجد كل شيء آخذ بالاختلاف، رويدا.
هنا، لن تجد سوى بنايتين من عمارات إيراد التقاعد، والبقية بيوت فخمة، بين قديم لم يمس، أو تم تحويله إلى مدرسة أهلية ـ مدرسة مرج العيون، ولا أدري ما يعني اسمها ـ وبين بيوت حديثة، مغلفة بواجهات أنيقة، احدها نسخة من البيوت الحلبية، حدائق فسيحة ونخيل واشجار جميلة ـ زرع البعض منهم الكينو كاربس القبيح ـ وبالتأكيد لن تعدم بيتا أنفقت عليه ملايين مملينة ليغلف بالمرمر الأبيض الصارخ، يقول لك أنا بيت ثري.
هنا، يندر أن تجد طفلا في الشارع إلا ليركب مع أهله في السيارة، وخلال سنتين من مروري اليومي هنا شاهدت مرة أو مرتين اطفال يقودون دراجة تحت رقابة الخادمة الصومالية، وفي الغالب لن تشاهد في الشارع سوى الخدم يغسلون الأرصفة، وسيارات القاطنين.
كان هناك بيت جميل، مما ابتني في الستينات، بواجهة متمايلة الاسقف، وانت تمر امامه، تدرك انه خالٍ إلا من الحراس، وسيارات قديمة الطراز مما صار تحف تجنى، ومؤخرا هدم، احتاجوا إلى سيارة تهديم ناضلت فيه لأيام قبل ان تتغلب عليه.
بعض البيوت تقول لك أنها بيوت لأخوين، بيوت توأم، يبدو أنها أقيمت على أنقاض بيت الأب، حافظ الأبناء على الموقع، والقرب، وذكرى الأب وإن هدموا الدار التي شادها بيده.
أجمل بيت في الشارع برأيي هورذاك الذي يقابل مستشفى جنين، ويحتل ركنين من الشارع، ليقع من الجانب الثاني على حاجز مرقد السيد ادريس، بيت مغلف بطابوق قديم فقط، يبدو لك مكعبا من الخارج بدون تفاصيل، لكن لو دققت النظر خلف الزخارف الخزفية التي تلعب دور كواسر الشمس فستجد مساحات داخلية رحبة، شرفات فسيحة، وحديقة تحتضن النخيل فحسب، بيت بخصوصية كبيرة لأصحابه، وهيمنة على الشارع المحيط به.
بالعودة إلى الوراء قليلا، ولو عبرنا الحاجز إلى الأفرع المحيطة بمرقد السيد إدريس، فتقريبا اغلب البيوت تحولت إلى عمارات ايراد التقاعد، مرتجلة، بلا إضاءة، تهوية سيئة، تغليف رث او بدون تغليف، تطل على مرقد الحسني، تبدو لي منظرا تقليديا تجده في كل البنى المحيطة بالمراقد الدينية، ولكن هنا، قرب السيد إدريس، في واحدة من أغلى مناطق الكرادة، كيف لك ان تفسره؟ لا ادري، اقرب ما استطيع قوله أن البيوت حول المرقد هي الأقدم ولا شك، وبقدر قدم البيت، وتباعد مبتنيه عن أيامنا، يتعدد الورثة، فيصير الحل الأقل خسارة هو بناء عمارة مرتجلة، تبقيهم في أماكنهم، وتسد عجز همتهم في الانتقال إلى بيت فسيح في منطقة جيدة، كما استطاع آبائهم أن يفعلوا من قبل.
كيف يمكن لشارعين متجاورين أن يختلفا بهذه الطريقة؟
هل نحتاج إلى مسح لكل الساكنين؟ لتاريخهم؟ لتبدلات الازمنة مع أسرهم؟ كيف يفكرون؟ كيف يتخذون خيارات حياتهم؟
هذه التناقضات العاصفة التي لا يفصل بينها شيء، متجاورة حائط لحائط، ماذا يفعل الناس بأنفسهم في سبيل خيارات غير محسوبة بشكل جيد؟