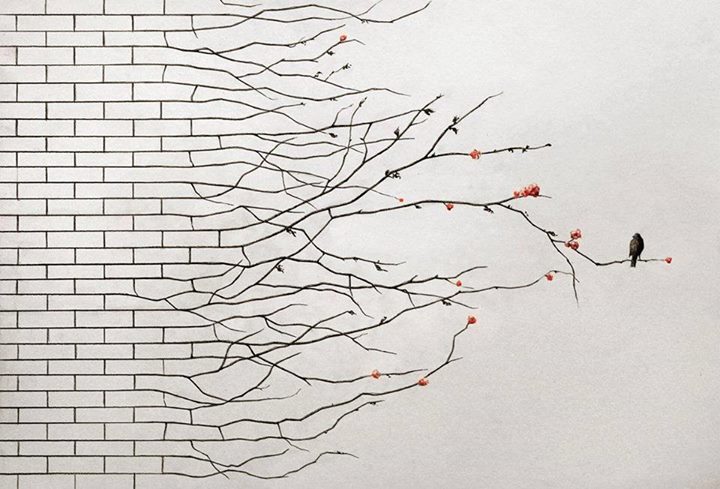علي المعموري
هل تسمعين تلك الهمسات التي تدب في كل شيء حولنا، تتحرك كالدماء في العروق؟
هل تشمين تلك العطور الغامضة التي تداعب الأرواح بلمسة شفافة كل لحظة؟ عذبة كالمياه بعد (الصيهود)، كالفرات يتمشى منذ آلاف من السنين، شامخاً، يحمل الحياة في عزف لا يكل ولا يفتر.
هل تبصرين ذلك الضوء، ذلك الضوء الذي يبدد العتمة رويدا، كما تغسل دجلة الغبار عن وجه بغداد؟ هل تحسين بنضارته؟ هل تمتلئ روحك من النسمات التي تعانقه وهو يتسلل في الأمشاج وئيداً؟ كالعافية تسري في جسد المريض، يفيق من إغماءته، وتصب عيناه في قلبه صور الأحبة المحيطين به، عيون رفعت إلى السماء أكف تدعوا، أفئدة تتضرع، تريد لنفوسها أن تصير دواءً، أن تصير كل شيء لهذا الذي يمثل لها كل شيء.
إنها أنت، ما غيرك.
إنه الرصاص الذي يلعلع حواليك، تقفين شامخة أزلية كالنخيل.
إنها نساءك التي تملأ المشاجب بالأحبة، وترص الذادة في المتاريس، كأنهن لم ينجبن، ولم يربين إلا لهذه اللحظة التي تتوج بالموت، الموت بكرامة.
إنها رجالك الذين يأبون التزحزح عن مواطئ الأقدام، حتى الجريح الذي يئس من النجاة، يجعل من نفسه قنبلة توقف البرابرة الهمج القادمين من مجاهل التاريخ.
إنها أطفالك الذين لبسوا الرجولة مبكرا، وألفوا البنادق قبل الألعاب، الذين فهموا ضرورة أن يجوعوا، وأن يعطشوا، وأن يفترشوا التراب الصاهد أسرة وثيرة، الذين تذوقوا لذة الكرامة مبكراً.
إنها الخيل التي تحمحم في المعركة، زمجرة الأسود التي تقتحم، الأعاصير التي لا تعرف السدود أمامها حيلة.
إنها الليالي التي كانت عتمتها أهون عليك من الضياء الذي يبصرك بالوجوه الكريهة التي تحيط بك، كل فجر مرَّ بك دون ندى، كل صباح لم تكن الحياة فيه أول ما يطرق أبوابك الساهدة، لم تكن العصافير تعلن مقدم الرزق، ولا الحمائم تهدل للسلام، كانت لعلعة الحرب تصطخب، البارود الذي تسيدت رائحته العفنة المشهد، تمتزج بصيدك الليلي من دماء الهمج، تنتظر الصيد القادم في النهار.
تقفين 83 يوما، كل يوم بسنة، الهمج يحيطون بك، يريدون كسرك، وأنت كالطود لا تتزحزحين عن مواضعك، الرصاصات تقل كل يوم، وأنت لا تزدادين إلا نصرا.
إنني أسمع، وأشم، وأحس.
كأن روحي أتون يلتهب لهفة عليك، يترقبك مع كل ما يخفق نحوي من جوف الليل، أقف ولست بالواقف، وأركض لا كما تركضين، أراك في كل الصور، تنعكس فيك كل الوجوه المحاصرة في مدن العراق.
ثلاثة أشهر والعار يصفعني كل لحظة، أحس بالعراق الذي تبدد، المياه التي تهشم إناؤها وتبخرت الحياة منها.
النجيع الذي يزمجر على أرض ما عرفته، يوما لم يسل فيه على خدها، النجيع الذي يعصف من تخوم الموصل، يخط بمسيره كل الحواضر، والقرى، والبيوت التي في طريقه، يضرب الأنبار، ويوجع ديالى، حتى يصل بغداد ليشوه وجهها النضر، ويجتث صدرها الناهد الذي طالما غنى له (جمال الدين).
ثلاثة أشهر، أجلس قرب المدخنين، أتطفل على نيكوتين المواجع الذي يحلق حول رؤوسهم، والشاي المر، والشتائم التي لا تدع أحدا في طريقها إلا وشجت “يافوخه”.
ثم جئت متألقة، وإذا بي لا أقدر على دموعي، تهرب من مقلتي دون إذن، إنها أنت، أنت الأمل الذي فتح روحي من جديد.
وها أنا أنتظر المدن القادمة، أنتظر لنواعير حديثة أن تهدل بالعراق وحده، أترقبها وقد لطمت البرابرة لطمة أخيرة تختم بها ما كالته لهم خلال الحصار، أنتظر الضلوعية، أن تهب من الأرض ضلوعا تحمي العراق، العلم التي تقف علما لا ينكس.
وبعد؟
أنتظر كل النهارات التي لا تقود إلا إلى الموصل…. الموصل التي إن لم تعد سريعا فلن يسد الثلم الذي أحدثته في كرامتنا شيء.
هل رأيت؟
إنها أنت التي قلت للعراقيين مرة أخرى: ارفعوا الرؤوس، انظروا إلى الأمل الذي يصب كالفجر من السماء، لملموا كرامتكم، فهي أغلى ما تملكون.
كل الطرق، كلها كانت تؤدي إليك، وأنت لا تؤدين إلا إلى الموصل.
أما أنت أيتها الحدباء، فلا تؤدين إلا إلى نفسك، على أمل أيتها البضة.
[الصيهود: هو الأسم الذي يطلق على موسم انخفاض مناسيب دجلة والفرات، بما يعني انقطاع الحياة، ويقابله اسم الخنياب ابان ارتفاع مناسيبها أول الربيع]