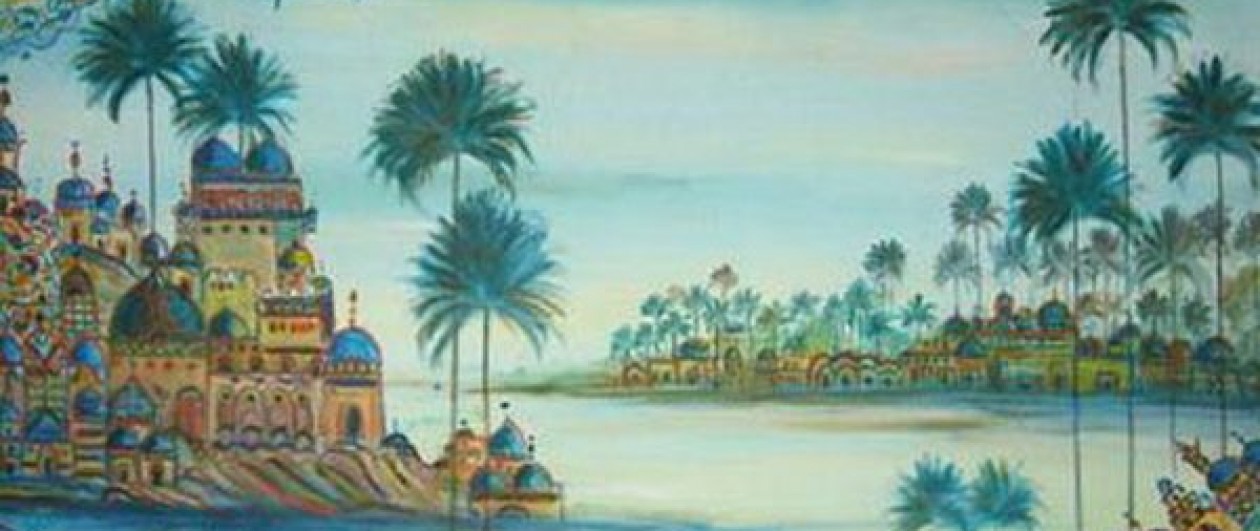(1)
كتبتُ مرة: (الأمم تصطنع رموزها اصطناعا، توجد لنفسها ما يملئ ذاتها عنفوانا ويمنحها الكبرياء اللازم للمقاومة والرفض والقدرة على المناجزة الطويلة عبر القرون، وتجاوز المفازات التاريخية بصمود واقتدار وتضحية تصنع الحياة، ولأكون أكثر تحديدا فليس كل من في التاريخ يمكن أن يكون رمزا، ولا يعني ان كل من اتخذه وعاظ السلاطين محورا لهرائهم وصنعوا حوله الهالات المزيفة يمكن ان يكون رمزا ينطبق عليه ما ذكرته، ولعل أول معالم الاستثنائية في شخص انسان ما هي أن يضطرب أبعد الناس عنه فكرا اعجابا أمام سيرته الاستنثنائية).
(2)
علاقة أي انسان بإنسان آخر، رمزا تاريخيا كان أم معاصرا، ترتبط بأمور كثيرة، بمواقف ترسخت عميقا في اللاوعي، بتأثيرات المكان والأسرة، وابن أبي طالب يمتلك معي كعراقي وشائج عديدة تشدني إليه شداً، روابط لا استطيع تجاوزها، صنعتها أمور كثيرة لعل أقل ما بينها الدين!
(3)
العارفون بعمارة النجف يعلمون ان المدينة القديمة تقوم على ثيمة معمارية يشكل مرقد الإمام مرتكزها الرئيس، “عـﮕود” تلتف مستديرة بين الأطراف الأربعة للنجف ـ طرف = محلة – كالسلاسل متقاطعة ما بينها، وكل “عـﮕد” يمتلك مخرج ومدخل لابد أن يقودك آخر الأمر إلى مرقد علي، يسير الإنسان بين جدران البيوت المتقاربة، وهواء “بادﮔيرات” السراديب الباردة يداعبك، بعيدا عن الهجير اللافح، “العـﮕود” تلتف على بعضها حتى تظن أنك في متاهة لن تخرج منها، ثم فجأة تجد نفسك في رحبة علي، كمن ينتقل من الأرض إلى السماء، وبالنسبة لطفل نجفي، فتلك اللحظات لا يمكن ان تنسى على الإطلاق، الباب الخشبي الضخم، الرخام البارد، الخدم بـ”كشايدهم” الحمراء “كشيدة=طربوش”، الأقفال الكبيرة، صوت “محمد عنوز” يرتفع من المأذنة، الأقواس المبطنة بالمرايا، السوباط الحاني، صوت الخادم وهو يصرخ حين يحين وقت إغلاق المرقد ـ حين كان يغلق منتصف الليل ـ ينادي منغما صوته الرخيم، والأقفال في يده: يا الله، يمدها مداً، ومنذ ذلك اليوم البعيد قبل ربع قرن، حتى اليوم، لم أسمع (يا الله) بجمال تلك التي سمعتها من ذلك الرجل، بكشيدته الحمراء، وقماشها الأسود الملتف حول فمها، ببدنه الضخم، ووجهه الأبيض وشواربه الخفيفة، يمسك عضادة الباب مرددا جملته مرارا وتكرارا، يستصرخ المحبين ان يذهبوا إلى بيوتهم، كمن ينفر سربا من الحمام عن مأمنه، لاحقا عرفت أن السادة من آل (القابجي) ينفردون بلف تلك القماشة السوداء على “كشايدهم”.
(4)
دعك من الأمور التي تخبرك أمك بها عن علي، دعك من علي الأسطوري، دعك مما تناثر في بطن “بحار الأنوار” من أخبار تجعل من علي كائن غيبي أقرب إلى المستحيل، دعك من هذا كله، واسمع تجربتي، أكثر من ربطني بعلي اثنان، المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، الذي يفقد سيطرته على نفسه حين يصل إلى ذكر علي، ثم يبدأ بضرب المنبر مرارا وتكرارا وهو يترنم باسمه، هذا في طفولتي، قبل اكتشاف القراءة وسحرها، الوائلي سلمني إلى من أجد أنهم أفضل من كتب عن علي: اليساريون بمختلف اصنافهم، قرأت هؤلاء بالتوازي مع تنامي حس الميل للعدالة الاجتماعية عندي، مع قراءتي للأدب العربي الساخط، مع الحزن الذي يهيمن على كتابات مصطفى لطفي المنفلوطي وبكائه على الجياع، ميل فطري إلى الفقراء تملكني، رغم أنني قضيت طفولة سعيدة لم يوجعني الحصار الذي ضرب العراق خلالها ـ تسعينات القرن الماضي ـ لم يصب أسرتي ما أصاب الآخرين على الأقل، ولم نحتج إلى بيع أثاث بيتنا، رغم ذلك كله، كنت لا أرى غير علي متجسد في صورة الفقراء، بحسراتهم الممتدة على طول العراق، الذي ما مر عام وليس فيه جوع كما قال السياب مرة.
(5)
قرأت علي الثائر، المبدئي، المتوجع للجياع حد البكاء، قرأته عند عبد الرحمن الشرقاوي، عند عبد الفتاح عبد المقصود، عند علي الوردي، عند شخص لم ينتمي سوى إلى مذهبه الشخصي مثل عباس محمود العقاد، عند الوائلي، هؤلاء وأضرابهم انتقلوا بي من علي الملكوتي الذي يصدح به الشعراء إلى علي الانسان الاستثنائي، علي الذي اختار أن يعود إلى جذوره العراقية، منتقلا من الحجاز إلى السواد، ليفتتح تاريخا طويلا من الثورات والبطولات الفردية، صانعا عنفوان أمة، متخذا من الفلاحين جنودا بوجه تجار قريش، رافضا أي حل وسط يزري بما آمن به، وما سار في سبيله حتى النهاية المدوية.
(6)
عند هذه النقطة وجدت ـ بعد سنوات ـ أن علياً المبدئي، الرافض لأنصاف الحلول، العصي على أن يقبل تسوية تؤلف بين ما يراه حقا وما يراه باطلا، وقدرته على أن يتحمل خياره الذي يعرف أنه خيار خاسر، ليسير به إلى آخر الخط، وتمكنه ـ بمختلف الأزمنة ـ من صنع أشخاص يتقبلون خيار الخسارة المزمن ذاك، وهم راضين عن انفسهم تمام الرضا، رغم أن علي يستطيع أن يسلك الطرق الأخرى، ولكن ما كان ليكون علي لو اتخذ تلك الطرق، عند تلك اللحظة عرفت أن علي، الذي يرفض أنصاف الحلول، والتسويات التي تمزج الحق بالباطل، هو اقرب إلى مزاج العراقيين غير القادرين على التسوية، غير القادرين على تقبل الحلول الوسطى، وإن اختلفوا عنه بمعيار الحق والباطل، وإن كانت عدم قدرتهم على التسوية تلك مزاجاً صنعته الأرض كما صنعه الرجال الرافضين لأنصاف الحلول مثل علي وبنوه، وهو ما جعل العراقيين المسلمين يذكرونه أكثر من ذكرهم ابن عمه النبي ومربيه، لهذا ارتبط علي في ذاكرتي بالعراق، وارتبط العراق بعلي.
(7)
أذهلتني قدرته الكبيرة على أن يكون قطب رحا لا يجرؤ على نكران فضله إلا موتور فارغ عاجز عن الإتيان على دليل بمزاعمه ضد علي، حتى أن الشعبي، وهو ممن اختلفوا عن خط علي تماما قال فيه يوما ما مضمونه أن اعدائه وظفوا أهل الحديث ضده، واستكروا ـ كما تستكرى البهيمة ـ الشعراء يمدحون آبائهم ويزرون بعلي، وآخر الأمر، وعند انجلاء العجاج، بدا وكأن الشعراء بمدحهم لأجداد أولئك كانوا يمدحون جيفة، وكأنهم إذ شتموا علياً كانوا يأخذون بضبعه إلى السماء! وخلال الألف ونصف الألف التي تلت إيابه إلى خالقه، بقي مناجزا، صامدا على تقلب الدهور، يحتل في القلوب مكانا لا يماثله فيه أحد، أذهلني أنه يتيح لي أن أحبه، دون أن أبغض أحد، أو اشتم أحد بحجة حبي لعلي.
(8)
كتب د. علي الوردي مرة أن ما من أمة اختلفت في رجل من رجالها كما اختلف المسلمون في علي، ولكنني اختلف مع الحكيم الوردي، وأظن أنهم اختلفوا عليه أكثر مما اختلفوا فيه، كل فريق أراد أن يحوز علي إلى خندقه، تقاتلوا على علي منذ وفاته إلى اليوم، كلٌ يرى أنه أولى بعلي وأحق من غيره به، ولكنه كان نسيج وحده، يحرك التاريخ رغم اختلاف الحدثان وتقلب الدهور، شاء من شاء وأبى من أبى.
(9)
كتبتُ مرة نصا أردته أن يكون قصيدة عنه، قلت في مطلعه:
“غريبون عنك
نغلف أرواحنا بالجليد
ونزعم أنا صنيع يديك”
ولا أزال.
فجر 17/6/2017
21رمضان 1438
[الصورة بعدستي: مرقد الإمام كما كان يبدو من بناية قرب منزلي، ولم يعد هذا المشهد متاحا]